

قد يعجبك أيضاً
-

وزير التعليم العالي ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تعزيز التعاون بين الجامعات والمحافظة في المجالات الصحية والتنموية
-

رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب جامعة القاهرة الاهلية والفرع الدولي مائدة السحور ويؤكد أهمية التواصل المباشر مع الطلاب
-

التعليم العالي : مفتي الجمهورية يشارك في ملتقى «قيم» لتعزيز وعي الشباب وبناء الشخصية المتوازنة
مرتبة جهاد الظلم والمنكر في الداخل
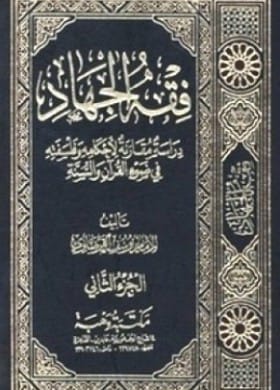
ومن مراتب الجهاد الذي جاء به الإسلام: مرتبة جهاد الشرِّ والفساد في الداخل. وهذا الجهاد في غاية الأهمية لحماية المجتمع من الضياع والانهيار والتفكُّك، لأن المجتمع المسلم له أسس ومقوِّمات وخصائص تميِّزه وتشخِّصه، فإذا ضُيِّعت أو نُسيت أو حُوربت هذه الأسس والمقوِّمات لم يبقَ مجتمعا مسلما.
• لكل مجتمع مسلم حارسان يحرسانه:
وهناك حارسان لهذا المجتمع يحفظانه ويمسكانه أن يزول:
هناك أولا: حارس الإيمان، الذي هو الأساس الأول للمجتمع. وهو حارس ذاتي من داخل ضمير كل مسلم.
وهناك ثانيا: هذا الحارس الاجتماعي، الذي يُجسِّد ضمير المجتمع العام، الذي يغار على العقائد أن تُخدش، وعلى الشعائر أن تُضيَّع، وعلى القِيَم أن تُداس، وعلى الحرمات أن تُنتهك، وعلى الشرائع أن تُعطل، وعلى الآداب أن تُهمل.
هذا الحارس ينشئه في المجتمع: أحكام الإسلام وتعاليمه، التي تجعل كل مسلم مسؤولا عما يحدث في المجتمع من حوله، فلا يعيش المسلم في همِّ نفسه وحدها، بل يحمل همَّ المجتمع من حوله، يقوِّم ما اعوجَّ، ويُصلح ما فسد، ويردُّ من شَرَدَ، ويقوِّم مَن ظَلم، حتى يستقيم المجتمع على أمر الله. فالمؤمن لا يكتفي بإصلاح نفسه، بل يعمل أبدا على إصلاح غيره، ومقاومة الفساد ما استطاع.
هذا ما تفرضه أوامر الإسلام ونواهيه: من النصيحة في الدين، والدعوة إلى الخير، والتواصي بالحق وبالصبر وبالمَرحمة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحاربة الطغيان، وتغيير المنكر - إذا وقع - باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. والأخذ على يد الظالم حتى يرتدع عن ظلمه، ونصرة المظلوم حتى يأخذ حقه.
• ميادين الجهاد في داخل المجتمع:
وهذا هو الجهاد الواجب في داخل المجتمع، وهو يشمل جملة ميادين:
( 1 ) ميدان مقاومة الظلم والظالمين:
ميدان مقاومة الظلم والظالمين، والأخذ على أيديهم، وعدم الركون إليهم، كما قال تعالى: {وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ} [هود:113[
والإسلام يطلب هنا من المسلم أمرين أساسيين: أولهما: ألا يظلم.
وثانيهما: ألا يكون عونا لظالم، فإن أعوان الظالم معه في جهنم. ولهذا يَدين القرآن جنود الطغاة كما يَدين الطغاة أنفسهم، كما في قوله سبحانه: {إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} [القصص:8]، وقال عن فرعون: {فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ} [القصص:40]، فاعتبر الطاغية والجنود جميعا من الظالمين، ونزلت نقمة الله فشملتهم جميعا، وأخذتهم جميعا بما قدمت أيديهم.
وذلك أن الجبار المستكبر في الأرض لا ينفذ ظلمه بنفسه، ولكن بوساطة هذه الآلات البشرية التي يستخدمها في قهر العباد، وإفساد البلاد، وهي تكون له عادة أطوع من الخاتم في أصبعه!
وقد قالوا: إن الإمام أحمد بن حنبل حين سُجن في محنة خلق القرآن الشهيرة، وأصابه من الأذى ما أصابه، سأله يوما أحد السجانين عن الأحاديث التي وردت في أعوان الظلمة وما لهم من العذاب عند الله تعالى؟ فأعلمه أنها أحاديث صحيحة. فقال له: وهل ترى مثلي من أعوان الظلمة؟ فقال له: لا، لست من أعوان الظلمة. إنما أعوان الظلمة مَن يخيط لك ثوبك، ومَن يهيئ لك طعامك، ومَن يقضي لك حاجتك. أما أنت فمن الظلمة أنفسهم !![1[
وقد جاء في الحديث الصحيح: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"! قالوا: يا رسول الله؛ ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال: "تحجزه - أو تمنعه - من الظلم، فإن ذلك نصره" .[2[
وسواء كان الظلم من الأغنياء للفقراء، أم من الملاَّك للمستأجرين، أم من أرباب العمل للعمال، أم من القادة للجنود، أم من الرؤساء للمرؤوسين، أم من الرجال للنساء، أم من الكبار للصغار، أم من الحكام وأولي الأمر للرعية والشعوب، فكله حرام ومنكر يجب أن يقاوَم ويجاهَد، بما يقدر عليه الإنسان من اليد، واللسان، والقلب، كما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريُّون وأصحاب، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خُلُوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يُؤمرون، فمَن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" .[3[
فأوجب الرسول صلى الله عليه وسلم: مجاهدة الظلمة والطغاة على كل مسلم، بما يقدر عليه: من اليد، أو اللسان، أو القلب، وهي المرتبة الأخيرة - التي مَن تركها لم يبقَ معه شيء من الإيمان، وإن قَلَّ - وضرب له مثلا بحبة الخردل على صغرها. والمطلوب في هذه المرتبة: أن يَكره الظلم والمنكر بقلبه، ويكره مرتكبي الظلم، ومقترفي المنكر، وهذه لا يملك أحد أن يمنعه منها، لأن قلب المؤمن لا سلطان لأحد عليه غير ربه الذي خلقه.
ولقد اهتمَّ الإسلام بهذا الجهاد وحثَّ عليه، وجاء في بعض الأحاديث اعتباره أفضل الجهاد، كما روى طارق بن شهاب البَجَلي رضي الله عنه: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضع رجله في الغَرْز: أي الجهاد أفضل؟ فقال: "كلمة حق عند سلطان جائر" . [4[
وروى جابر بن عبد الله، عن النبي صلى اله عليه وسلم قال: "سيد الشهداء: حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله" [5]. وبهذا جرَّأ الرسول الكريم أمته: أن تقول كلمة الحق في وجه السلاطين الظلمة المتجبِّرين، لا يبالون ما يصيبهم في سبيل الله؛ أن يقتلوا في سبيل الله. وهذا أغلى وأعلى ما يتمناه مسلم لنفسه: أن يُختم له بالشهادة في سبيل الله، ولا سيما إذا كان بجوار سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله.
وتظلُّ الأمة بخير ما دام فيها مَن يصدع بكلمة الحق آمرا ناهيا، مهما تكن العاقبة. وتفقد الأمة استحقاقها للبقاء، إذا شاعت فيها روح الاستسلام، وانتشر فيها الوَهْن والجبن، وعدمت مَن يقول: أمتي، أمتي! قبل أن يقول: نفسي، نفسي!
وهذا ما حذَّر منه الحديث الشريف الذي يقول: "إذا رأيتَ أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تُودِّع منهم" [6[
ومعنى "تودِّع منهم": أي لا خير فيهم، فقد استوى وجودهم وعدمهم، فإن مبرِّر وجود الأمة: أن تقوم برسالتها، وهي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لم تقُم بهذه الرسالة فلم تعُد فائدة لبقائها.
• وقفة للتأمل في سبب تعظيم الرسول لهذا الجهاد :
ويَحْسُن بنا أن نقف هنا وقفة للتأمل والمقارنة: لماذا عظَّم الرسول الكريم شأن هذا الجهاد، واعتبره أفضل الجهاد، واعتبر مَن قُتل فيه بجوار سيد الشهداء؟
والجواب: أن خطر الفساد الداخلي إذا تفاقم: يشكل خطرا جسيما وشرا كبيرا على الأمة، ولهذا يعتبر الإسلام الجهاد ضدَّ الظلم والفساد في الداخل مقدَّما على الجهاد ضدَّ الكفر والعدوان من الخارج. فإن الفساد الداخلي كثيرا ما يكون ممهِّدا للعدوان الخارجي، كما تدلُّ على ذلك أوائل سورة الإسراء، إذ قصَّت علينا ما وقع لبني إسرائيل حين أفسدوا في الأرض مرتين، وعلَوا (طغَوا) علوًّا كبيرا، ولم يجدوا بينهم مَن ينهى عن هذا الفساد أو يقاوِمه، فسلَّط الله عليهم أعداء من الخارج، يجوسون خلال ديارهم، ويدمِّرون عليهم معابدهم، ويحرقون توراتهم، ويسومونهم سوء العذاب، ويتبِّرون ما علَوا تتبيرا، وكان وعد الله مفعولا.
ومن هنا رأينا الفساد والانحلال، مقدمة للغزو والاحتلال [7]، وقد هدَّدهم بمثل هذه العقوبات القدرية إذا وقع منهم مثل ذلك الإفساد في المستقبل، وذلك في قوله تعالى: {عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا} [الإسراء:8]، أي إن عُدتم إلى الطغيان والعلو والإفساد عُدنا عليكم بتسليط الأعداء.
وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا: أن أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر. فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل الجهاد، لأن المقاتل في الميدان كثيرا ما يَسلم ويعود بأجر وغنيمة، أما مَن يواجه السلطان الجائر بكلمة الحق، فكثيرا ما يقدِّم عنقه فداء لكلمته.
وأساس هذه المراتب هو حديث أبي سعيد الخدري[8]، وحديث ابن مسعود، اللذين رواهما مسلم في صحيحه [9[
وجعل ابن القيم هذا النوع من الجهاد ثلاث مراتب: باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، حسب الاستطاعة.
• مفهوم الجهاد أو التغيير بالقلب:
والتغيير بالقلب أو الجهاد بالقلب: معناه غليان القلب غضبا على المنكر، وكراهية للظلم، وإنكارا على الفساد. وحين يمتلئ القلب بهذه (الشحنة) من الغضب والكراهية والإنكار والثورة الداخلية: يكون ذلك تحضيرا معنويا لثورة ظاهرية عارمة، توشك أن تقتلع الظلم والفساد من جذوره، حين يرى المؤمن الظلم يتجبَّر، والفساد يستشري، والمنكر يستعلي، ولا يستطيع تغييره بيد ولا حتى بلسان، فيذوب قلبه كما يذوب المِلح في الماء، ويغلي الغيظ في صدره، كما يغلي المِرجَل فوق النار؛ فلا بد لهذا المِرجَل أن يتنفس، وإلا تفجَّر أو تكسَّر! فهذه الشحنة القلبية الوجدانية الانفعالية: رصيد مهم لأي تغيير عملي مرتقَب، فإن التغيير لا يبدأ عادة من فراغ، بل لا بد له من مقدِّمات ودوافع نفسية، تغري به، وتدفع إليه.
فليس التغيير أو الجهاد بالقلب موقفا سلبيا، كما يفهمه بعض الناس، وإلا ما سمَّاه الرسول تغييرا أو جهادا، ولا جعله مرتبة من مراتب الإيمان، وإن كان هو المرتبة الدنيا، التي ليس وراءها من الإيمان حبة خردل.
ولهذا كان جهاد الفساد لازما ومفضَّلا على غيره، إنقاذا للأمة من شروره وآثاره، وإطفاءً للنار قبل أن يتطاير شررها، ويتفاقم خطرها، ويعمَّ ضررها.
وإذا كانت السنة النبوية قد نوَّهت بفضل من قُتِل من أجل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن القرآن قد ندَّد أبلغ التنديد بالذين يَقتُلون الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، من الأنبياء، وورثة الأنبياء، الذين يواجهون أهواء الباطل بكلمة الحق. واعتبر القرآن هذه الجريمة من كبريات الجرائم، التي تستوجب عذاب الله ونقمته في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} [آل عمران:22،21].
وذلك لأن هذه الجريمة تُخرس ألسنة الحق، وتُخْلِي الساحة للطغاة والظالمين، يعملون فيها ما تَهوى أنفسهم، وما تُزينه لهم شياطينهم، وإن بلغ في الشر ما بلغ، دون أن يقول لهم أحد: لم؟ بله أن يقول لهم: لا!
ومن هنا كانت عقوبة الله تعالى لبني إسرائيل، إذ كان من جرائمهم التي شاعت فيهم: قتل الأنبياء بغير حق. كما قال تعالى: {أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ} [البقرة:87].
وقال سبحانه: {ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} [آل عمران:112].
( 2 ) ميدان مقاومة الفسوق والانحلال:
وهناك ميدان ثانٍ للجهاد الداخلي، ذلك هو ميدان الانحلال والفسوق، واقتراف المعاصي، واتباع الشهوات. وهو انحراف خطير، إذا استسلمت له الأمة ساقها إلى مهاوي الرَّدَى، واختلَّت أمور حياتها كلِّها، وظهر الفساد والاختلال في البر والبحر بسوء أعمالها، واعوجاج سلوكها. كما قال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الروم:41]، والفساد المذكور في الآية ليس المراد به الفساد الديني والخلقي، بل فساد أمر الحياة واضطراب موازينها، واختلال شؤونها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بظهور الفقر والبطالة والغلاء، وانتشار الأمراض، وتقطُّع الروابط، وغلبة الجَور، واتساع الفوارق بين الناس، حتى تجد كل الناس يشتكون من سوء الحال، وخيبة الآمال.
أما الفساد الديني والخلقي فهو سبب للفساد الدنيوي المذكور في الآية، وهو المعبَّر عنه بقوله تعالى: {بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ} فإن الله لا يعاقب الناس إلا بما عملوا، كما قال تعالى: {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [آل عمران:182، الأنفال:51]، وقال: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الأنفال:53].
وهو سبحانه لا يعاقب الناس بكل ما عملوا، بل كما قال تعالى: {لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا} [الروم:41]، وكما قال عز وجل: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى:30]، ويقول تعالى: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً} [فاطر:45].
إن اتباع شهوات البطون والفروج، والاستهانة بما حرَّم الله على عباده، واقتراف الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من الزنى، الذي حذَّر الله ونهى عن مجرَّد الاقتراب منه، فقال: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء:32]، ومن الشذوذ الجنسي؛ الذي عُرف بعمل قوم لوط، الذين أَتَوا هذه الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، والذين أرسل الله إلى مرتكبيها رسولا ينهاهم عنها، ويحذِّرهم من مغبَّتها، وينذرهم بسوء المصير إن هم أصرُّوا عليها، ومن قوله لهم: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} [الشعراء:166،165]، وفي سور أخرى قال لهم: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [النمل:55]، {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} [الأعراف:81]، {فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ} [الأعراف:84]، {رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ} [العنكبوت:30]، {إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ} [الأنبياء:74]، فوصفهم بالعدوان، والجهل، والإسراف، والإجرام، والإفساد، والفسوق، وأنهم قوم سوء.
ولم يُجدِ فيهم تحذير أو إنذار، فلقد كانوا في {سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الحجر:72]، كما وصفهم القرآن، وهو تصوير صادق لحال المدمنين على الفاحشة، الذين فقدوا عقولهم وإرادتهم، وأصرُّوا على إباحيتهم وشذوذهم، فكان لا بد للقدر الأعلى أن يطهِّر الأرض من رجسهم بعذاب من السماء يدمِّر قريتهم، ويهلك أشخاصهم: {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ * مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} [هود:83،82].
إن انتشار فاحشة الزنى والشذوذ - الذي أصبح له دعاة ومروِّجون جهارا نهارا في عصرنا - سبب لنقمة الله تعالى، وعقوبته القَدَرية للمجتمعات المصابة بهذه الأدواء، كما جاء في حديث ابن عمر، عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وفيه: "لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا سلَّط الله عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضَوا" [10].
وجاء في حديث ابن مسعود: "ما ظهر في قوم الزنى والربا إلا أَحلُّوا بأنفسهم عقاب الله" [11].
ومن ذلك: شرب الخمر أم الخبائث، وشيوع تناول المسكرات والمخدِّرات، التي تفسد عقول أبناء الأمة، كما تفسد أجسامها وعزائمها، وتشيع فيها الأدواء والأمراض، وتضيع المليارات من أموالها في محاربتها ثم في علاجها، وعلاج آثارها السيئة على المجتمع.
إن الفسوق والانحلال جريمة كبيرة مدمِّرة للمجتمعات إذا لم تقاوَم، ولا سيما في الأمم التي تقوم أساسا على الدين، والدين يعني: الطهر والاستقامة والعفاف والإحصان.
( 3 ) ميدان مقاومة الابتداع والانحراف الفكري:
وهنا ميدان ثالث ومهم للجهاد الداخلي، وهو ميدان الابتداع في الدين، بأن يحدث فيه ما ليس منه، وأن يزيد عليه ما لا تقبله طبيعته في عقيدته أو شريعته أو أخلاقه، أو تقاليده، أو يدعو إلى مفاهيم تتناقض مع عقائده أو شرائعه أو قِيَمه.
والإسلام - خاصة - شديد الحساسية نحو الابتداع والإحداث في الدين، والمناقضة في الفكر. لذا قال رسوله الكريم: "مَن أحدث في أمرنا ما ليس من، فهو ردٌّ" [12]، ومعنى "في أمرنا": أي في ديننا. ومعنى "فهو رَدٌّ": أي مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: "كلُّ بدعة ضلالة، وكلُّ ضلالة في النار" [13].
ويرى الراسخون في العلم: أن البدع أشد خطرا من المعاصي؛ لأن المعاصي مكشوفة مفضوح أمرها للناس. أما البدع فهي تتستَّر بثوب الدين، وتروج بضاعتها عند الكثيرين على أنها قُرَب إلى الله تعالى، ولا يعرفون حقيقتها. ولذا قالوا: إن المعصية كثيرا ما نرى أصحابها يندمون عليها، ويتوبون ويستغفرون الله تعالى. أما البدعة فإن أصحابها لا يتوبون منها، ولا يستغفرون، لأنهم يتقربون إلى الله بها، فكيف يتوبون منها ويستغفرون؟!
ولهذا قالوا: إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. فإن المعصية تفسد الإنسان، ولكن البدعة تفسد الأديان.
• البدعة القولية (الاعتقادية والفكرية) والبدعة العملية:
والابتداع - كما شرحه العلماء - نوعان:
1. ابتداع بالفعل.
2. وابتداع بالقول.
وقد حذَّر العلماء من النوعين جميعا: بدعة الأفعال، وبدعة الأقوال.
وبدعة الأفعال تتعلق بالعمل والسلوك، وبدعة الأقوال تتعلق بالاعتقاد والأفكار.
ولذلك كانت البدعة الاعتقادية والفكرية: أشدُّ خطرا من البدعة العملية والسلوكية.
فإن الإنسان لا يستقيم سلوكه وعمله إلا إذا استقام اعتقاده وفكره وتصوره. فإذا اعوجَّ هذا الاعتقاد أو الفكر أو التصور: اعوجَّ العمل والسلوك لا محالة. إذ لا يستقيم الظلُّ والعود أعوج!
وهذا النوع من الابتداع والانحراف: هو سبب لكثير من الفتن والصراعات التي حدثت في تاريخنا الإسلامي، وأدَّت إلى حروب ودماء وخراب ودمار، وفرَّقت الأمة الواحدة إلى طوائف وفرق، يُفسِّق بعضها بعضا؛ بل يُكفِّر بعضها بعضا، وترتَّب على هذا: أن يقاتل بعضها بعضا، ويرفع أحدهم السيف في وجه أخيه المسلم؛ مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لهم في حَجَّة الوداع بالقول الصريح، والإنذار المبين: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" [14].
وقوله: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" [15].
إن بدعة الخوارج لم تنشأ عن فساد في السلوك أو تقصير في عبادة الله، فقد كانوا صُوَّاما قُوَّاما قُرَّاء للقرآن، حتى جاء في الحديث الصحيح: "يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم". ومع هذا وصفهم بأنهم "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة"، وأنهم "يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم" [16]، أي أنهم يقرؤونه بحناجرهم، ولا يحسنون فقهه بعقولهم. فآفتهم ليست في فساد القصد، بل في فساد الفَهم، آفتهم ليست في ضمائرهم، بل في عقولهم.
لهذا يقرر الإمام ابن تيمية في أحد المباحث في فتاواه : (أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة (أمراء) الظلم ، وقال في الذي يشرب الخمر : "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله" وقال في ذي الخويصرة : "يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين - وفي رواية من الإسلام - كما يمرق السهم من الرمية يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة" ) [17]
وهذا الاعوجاج في الفَهم أدَّى إلى الخروج على الأمة، واستباحة دمائها، حتى استباحوا دم ابن الإسلام البكر: علي بن أبي طالب!
وفي عصرنا نجد الابتداعات أو الانحرافات الفكرية هي أخطر ما يواجه الأمة، وهو ما يسعى أعداؤها بكل قوة، وبكل وضوح إلى تسويقه ونشره بين أبنائها، لتحريف مسيرتها، وتزييف وعيها، والتلبيس عليها، فلا تتبيَّن لها غاية، ولا يتَّضح لها طريق، وبهذا لا يمكنها أن تجتمع على شيء بيِّن. ولهذا كان أخطر أنواع الغزو الذي تواجهه الأمة المسلمة اليوم هو الغزو الفكري ، الذي لا يحاربنا بالسيف ، بل بالعلم ، ولا يهتم كثيرا بقتل الأفراد ، بل بقتل المجتمعات .
إن الأفكار (العلمانية) التي تنادي بفصل الدين عن الحياة والمجتمع. و(الليبرالية) التي تنادي بالحرية المطلقة للفسوق والانحلال والشذوذ والفواحش. و(الماركسية) التي تدعو إلى المادية الجدلية، ومقاومة الفكرة الدينية، ونسبية القِيَم الأخلاقية، وتحريم الملكية الفردية، ومصادرة الحرية الإنسانية: كلُّها ثمرة لهذا الابتداع أو الانحراف الفكري والاعتقادي. والثمرة لا بد أن تكون من جنس البذرة، {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً} [الأعراف:58].
لهذا كان لابد من كشف مساؤئها ، وبيان بطلان مبادئها ، ومقاومة انتشارها ، ووقاية الأمة من شررها وشرورها ، وكل هذا داخل في الجهاد.
• لكل مجتمع مسلم حارسان يحرسانه:
وهناك حارسان لهذا المجتمع يحفظانه ويمسكانه أن يزول:
هناك أولا: حارس الإيمان، الذي هو الأساس الأول للمجتمع. وهو حارس ذاتي من داخل ضمير كل مسلم.
وهناك ثانيا: هذا الحارس الاجتماعي، الذي يُجسِّد ضمير المجتمع العام، الذي يغار على العقائد أن تُخدش، وعلى الشعائر أن تُضيَّع، وعلى القِيَم أن تُداس، وعلى الحرمات أن تُنتهك، وعلى الشرائع أن تُعطل، وعلى الآداب أن تُهمل.
هذا الحارس ينشئه في المجتمع: أحكام الإسلام وتعاليمه، التي تجعل كل مسلم مسؤولا عما يحدث في المجتمع من حوله، فلا يعيش المسلم في همِّ نفسه وحدها، بل يحمل همَّ المجتمع من حوله، يقوِّم ما اعوجَّ، ويُصلح ما فسد، ويردُّ من شَرَدَ، ويقوِّم مَن ظَلم، حتى يستقيم المجتمع على أمر الله. فالمؤمن لا يكتفي بإصلاح نفسه، بل يعمل أبدا على إصلاح غيره، ومقاومة الفساد ما استطاع.
هذا ما تفرضه أوامر الإسلام ونواهيه: من النصيحة في الدين، والدعوة إلى الخير، والتواصي بالحق وبالصبر وبالمَرحمة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحاربة الطغيان، وتغيير المنكر - إذا وقع - باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. والأخذ على يد الظالم حتى يرتدع عن ظلمه، ونصرة المظلوم حتى يأخذ حقه.
• ميادين الجهاد في داخل المجتمع:
وهذا هو الجهاد الواجب في داخل المجتمع، وهو يشمل جملة ميادين:
( 1 ) ميدان مقاومة الظلم والظالمين:
ميدان مقاومة الظلم والظالمين، والأخذ على أيديهم، وعدم الركون إليهم، كما قال تعالى: {وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ} [هود:113[
والإسلام يطلب هنا من المسلم أمرين أساسيين: أولهما: ألا يظلم.
وثانيهما: ألا يكون عونا لظالم، فإن أعوان الظالم معه في جهنم. ولهذا يَدين القرآن جنود الطغاة كما يَدين الطغاة أنفسهم، كما في قوله سبحانه: {إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} [القصص:8]، وقال عن فرعون: {فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ} [القصص:40]، فاعتبر الطاغية والجنود جميعا من الظالمين، ونزلت نقمة الله فشملتهم جميعا، وأخذتهم جميعا بما قدمت أيديهم.
وذلك أن الجبار المستكبر في الأرض لا ينفذ ظلمه بنفسه، ولكن بوساطة هذه الآلات البشرية التي يستخدمها في قهر العباد، وإفساد البلاد، وهي تكون له عادة أطوع من الخاتم في أصبعه!
وقد قالوا: إن الإمام أحمد بن حنبل حين سُجن في محنة خلق القرآن الشهيرة، وأصابه من الأذى ما أصابه، سأله يوما أحد السجانين عن الأحاديث التي وردت في أعوان الظلمة وما لهم من العذاب عند الله تعالى؟ فأعلمه أنها أحاديث صحيحة. فقال له: وهل ترى مثلي من أعوان الظلمة؟ فقال له: لا، لست من أعوان الظلمة. إنما أعوان الظلمة مَن يخيط لك ثوبك، ومَن يهيئ لك طعامك، ومَن يقضي لك حاجتك. أما أنت فمن الظلمة أنفسهم !![1[
وقد جاء في الحديث الصحيح: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"! قالوا: يا رسول الله؛ ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال: "تحجزه - أو تمنعه - من الظلم، فإن ذلك نصره" .[2[
وسواء كان الظلم من الأغنياء للفقراء، أم من الملاَّك للمستأجرين، أم من أرباب العمل للعمال، أم من القادة للجنود، أم من الرؤساء للمرؤوسين، أم من الرجال للنساء، أم من الكبار للصغار، أم من الحكام وأولي الأمر للرعية والشعوب، فكله حرام ومنكر يجب أن يقاوَم ويجاهَد، بما يقدر عليه الإنسان من اليد، واللسان، والقلب، كما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريُّون وأصحاب، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خُلُوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يُؤمرون، فمَن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" .[3[
فأوجب الرسول صلى الله عليه وسلم: مجاهدة الظلمة والطغاة على كل مسلم، بما يقدر عليه: من اليد، أو اللسان، أو القلب، وهي المرتبة الأخيرة - التي مَن تركها لم يبقَ معه شيء من الإيمان، وإن قَلَّ - وضرب له مثلا بحبة الخردل على صغرها. والمطلوب في هذه المرتبة: أن يَكره الظلم والمنكر بقلبه، ويكره مرتكبي الظلم، ومقترفي المنكر، وهذه لا يملك أحد أن يمنعه منها، لأن قلب المؤمن لا سلطان لأحد عليه غير ربه الذي خلقه.
ولقد اهتمَّ الإسلام بهذا الجهاد وحثَّ عليه، وجاء في بعض الأحاديث اعتباره أفضل الجهاد، كما روى طارق بن شهاب البَجَلي رضي الله عنه: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضع رجله في الغَرْز: أي الجهاد أفضل؟ فقال: "كلمة حق عند سلطان جائر" . [4[
وروى جابر بن عبد الله، عن النبي صلى اله عليه وسلم قال: "سيد الشهداء: حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله" [5]. وبهذا جرَّأ الرسول الكريم أمته: أن تقول كلمة الحق في وجه السلاطين الظلمة المتجبِّرين، لا يبالون ما يصيبهم في سبيل الله؛ أن يقتلوا في سبيل الله. وهذا أغلى وأعلى ما يتمناه مسلم لنفسه: أن يُختم له بالشهادة في سبيل الله، ولا سيما إذا كان بجوار سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله.
وتظلُّ الأمة بخير ما دام فيها مَن يصدع بكلمة الحق آمرا ناهيا، مهما تكن العاقبة. وتفقد الأمة استحقاقها للبقاء، إذا شاعت فيها روح الاستسلام، وانتشر فيها الوَهْن والجبن، وعدمت مَن يقول: أمتي، أمتي! قبل أن يقول: نفسي، نفسي!
وهذا ما حذَّر منه الحديث الشريف الذي يقول: "إذا رأيتَ أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تُودِّع منهم" [6[
ومعنى "تودِّع منهم": أي لا خير فيهم، فقد استوى وجودهم وعدمهم، فإن مبرِّر وجود الأمة: أن تقوم برسالتها، وهي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لم تقُم بهذه الرسالة فلم تعُد فائدة لبقائها.
• وقفة للتأمل في سبب تعظيم الرسول لهذا الجهاد :
ويَحْسُن بنا أن نقف هنا وقفة للتأمل والمقارنة: لماذا عظَّم الرسول الكريم شأن هذا الجهاد، واعتبره أفضل الجهاد، واعتبر مَن قُتل فيه بجوار سيد الشهداء؟
والجواب: أن خطر الفساد الداخلي إذا تفاقم: يشكل خطرا جسيما وشرا كبيرا على الأمة، ولهذا يعتبر الإسلام الجهاد ضدَّ الظلم والفساد في الداخل مقدَّما على الجهاد ضدَّ الكفر والعدوان من الخارج. فإن الفساد الداخلي كثيرا ما يكون ممهِّدا للعدوان الخارجي، كما تدلُّ على ذلك أوائل سورة الإسراء، إذ قصَّت علينا ما وقع لبني إسرائيل حين أفسدوا في الأرض مرتين، وعلَوا (طغَوا) علوًّا كبيرا، ولم يجدوا بينهم مَن ينهى عن هذا الفساد أو يقاوِمه، فسلَّط الله عليهم أعداء من الخارج، يجوسون خلال ديارهم، ويدمِّرون عليهم معابدهم، ويحرقون توراتهم، ويسومونهم سوء العذاب، ويتبِّرون ما علَوا تتبيرا، وكان وعد الله مفعولا.
ومن هنا رأينا الفساد والانحلال، مقدمة للغزو والاحتلال [7]، وقد هدَّدهم بمثل هذه العقوبات القدرية إذا وقع منهم مثل ذلك الإفساد في المستقبل، وذلك في قوله تعالى: {عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا} [الإسراء:8]، أي إن عُدتم إلى الطغيان والعلو والإفساد عُدنا عليكم بتسليط الأعداء.
وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا: أن أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر. فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل الجهاد، لأن المقاتل في الميدان كثيرا ما يَسلم ويعود بأجر وغنيمة، أما مَن يواجه السلطان الجائر بكلمة الحق، فكثيرا ما يقدِّم عنقه فداء لكلمته.
وأساس هذه المراتب هو حديث أبي سعيد الخدري[8]، وحديث ابن مسعود، اللذين رواهما مسلم في صحيحه [9[
وجعل ابن القيم هذا النوع من الجهاد ثلاث مراتب: باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، حسب الاستطاعة.
• مفهوم الجهاد أو التغيير بالقلب:
والتغيير بالقلب أو الجهاد بالقلب: معناه غليان القلب غضبا على المنكر، وكراهية للظلم، وإنكارا على الفساد. وحين يمتلئ القلب بهذه (الشحنة) من الغضب والكراهية والإنكار والثورة الداخلية: يكون ذلك تحضيرا معنويا لثورة ظاهرية عارمة، توشك أن تقتلع الظلم والفساد من جذوره، حين يرى المؤمن الظلم يتجبَّر، والفساد يستشري، والمنكر يستعلي، ولا يستطيع تغييره بيد ولا حتى بلسان، فيذوب قلبه كما يذوب المِلح في الماء، ويغلي الغيظ في صدره، كما يغلي المِرجَل فوق النار؛ فلا بد لهذا المِرجَل أن يتنفس، وإلا تفجَّر أو تكسَّر! فهذه الشحنة القلبية الوجدانية الانفعالية: رصيد مهم لأي تغيير عملي مرتقَب، فإن التغيير لا يبدأ عادة من فراغ، بل لا بد له من مقدِّمات ودوافع نفسية، تغري به، وتدفع إليه.
فليس التغيير أو الجهاد بالقلب موقفا سلبيا، كما يفهمه بعض الناس، وإلا ما سمَّاه الرسول تغييرا أو جهادا، ولا جعله مرتبة من مراتب الإيمان، وإن كان هو المرتبة الدنيا، التي ليس وراءها من الإيمان حبة خردل.
ولهذا كان جهاد الفساد لازما ومفضَّلا على غيره، إنقاذا للأمة من شروره وآثاره، وإطفاءً للنار قبل أن يتطاير شررها، ويتفاقم خطرها، ويعمَّ ضررها.
وإذا كانت السنة النبوية قد نوَّهت بفضل من قُتِل من أجل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن القرآن قد ندَّد أبلغ التنديد بالذين يَقتُلون الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، من الأنبياء، وورثة الأنبياء، الذين يواجهون أهواء الباطل بكلمة الحق. واعتبر القرآن هذه الجريمة من كبريات الجرائم، التي تستوجب عذاب الله ونقمته في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} [آل عمران:22،21].
وذلك لأن هذه الجريمة تُخرس ألسنة الحق، وتُخْلِي الساحة للطغاة والظالمين، يعملون فيها ما تَهوى أنفسهم، وما تُزينه لهم شياطينهم، وإن بلغ في الشر ما بلغ، دون أن يقول لهم أحد: لم؟ بله أن يقول لهم: لا!
ومن هنا كانت عقوبة الله تعالى لبني إسرائيل، إذ كان من جرائمهم التي شاعت فيهم: قتل الأنبياء بغير حق. كما قال تعالى: {أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ} [البقرة:87].
وقال سبحانه: {ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} [آل عمران:112].
( 2 ) ميدان مقاومة الفسوق والانحلال:
وهناك ميدان ثانٍ للجهاد الداخلي، ذلك هو ميدان الانحلال والفسوق، واقتراف المعاصي، واتباع الشهوات. وهو انحراف خطير، إذا استسلمت له الأمة ساقها إلى مهاوي الرَّدَى، واختلَّت أمور حياتها كلِّها، وظهر الفساد والاختلال في البر والبحر بسوء أعمالها، واعوجاج سلوكها. كما قال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الروم:41]، والفساد المذكور في الآية ليس المراد به الفساد الديني والخلقي، بل فساد أمر الحياة واضطراب موازينها، واختلال شؤونها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بظهور الفقر والبطالة والغلاء، وانتشار الأمراض، وتقطُّع الروابط، وغلبة الجَور، واتساع الفوارق بين الناس، حتى تجد كل الناس يشتكون من سوء الحال، وخيبة الآمال.
أما الفساد الديني والخلقي فهو سبب للفساد الدنيوي المذكور في الآية، وهو المعبَّر عنه بقوله تعالى: {بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ} فإن الله لا يعاقب الناس إلا بما عملوا، كما قال تعالى: {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [آل عمران:182، الأنفال:51]، وقال: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الأنفال:53].
وهو سبحانه لا يعاقب الناس بكل ما عملوا، بل كما قال تعالى: {لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا} [الروم:41]، وكما قال عز وجل: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى:30]، ويقول تعالى: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً} [فاطر:45].
إن اتباع شهوات البطون والفروج، والاستهانة بما حرَّم الله على عباده، واقتراف الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من الزنى، الذي حذَّر الله ونهى عن مجرَّد الاقتراب منه، فقال: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء:32]، ومن الشذوذ الجنسي؛ الذي عُرف بعمل قوم لوط، الذين أَتَوا هذه الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، والذين أرسل الله إلى مرتكبيها رسولا ينهاهم عنها، ويحذِّرهم من مغبَّتها، وينذرهم بسوء المصير إن هم أصرُّوا عليها، ومن قوله لهم: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} [الشعراء:166،165]، وفي سور أخرى قال لهم: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [النمل:55]، {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} [الأعراف:81]، {فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ} [الأعراف:84]، {رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ} [العنكبوت:30]، {إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ} [الأنبياء:74]، فوصفهم بالعدوان، والجهل، والإسراف، والإجرام، والإفساد، والفسوق، وأنهم قوم سوء.
ولم يُجدِ فيهم تحذير أو إنذار، فلقد كانوا في {سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الحجر:72]، كما وصفهم القرآن، وهو تصوير صادق لحال المدمنين على الفاحشة، الذين فقدوا عقولهم وإرادتهم، وأصرُّوا على إباحيتهم وشذوذهم، فكان لا بد للقدر الأعلى أن يطهِّر الأرض من رجسهم بعذاب من السماء يدمِّر قريتهم، ويهلك أشخاصهم: {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ * مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} [هود:83،82].
إن انتشار فاحشة الزنى والشذوذ - الذي أصبح له دعاة ومروِّجون جهارا نهارا في عصرنا - سبب لنقمة الله تعالى، وعقوبته القَدَرية للمجتمعات المصابة بهذه الأدواء، كما جاء في حديث ابن عمر، عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وفيه: "لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا سلَّط الله عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضَوا" [10].
وجاء في حديث ابن مسعود: "ما ظهر في قوم الزنى والربا إلا أَحلُّوا بأنفسهم عقاب الله" [11].
ومن ذلك: شرب الخمر أم الخبائث، وشيوع تناول المسكرات والمخدِّرات، التي تفسد عقول أبناء الأمة، كما تفسد أجسامها وعزائمها، وتشيع فيها الأدواء والأمراض، وتضيع المليارات من أموالها في محاربتها ثم في علاجها، وعلاج آثارها السيئة على المجتمع.
إن الفسوق والانحلال جريمة كبيرة مدمِّرة للمجتمعات إذا لم تقاوَم، ولا سيما في الأمم التي تقوم أساسا على الدين، والدين يعني: الطهر والاستقامة والعفاف والإحصان.
( 3 ) ميدان مقاومة الابتداع والانحراف الفكري:
وهنا ميدان ثالث ومهم للجهاد الداخلي، وهو ميدان الابتداع في الدين، بأن يحدث فيه ما ليس منه، وأن يزيد عليه ما لا تقبله طبيعته في عقيدته أو شريعته أو أخلاقه، أو تقاليده، أو يدعو إلى مفاهيم تتناقض مع عقائده أو شرائعه أو قِيَمه.
والإسلام - خاصة - شديد الحساسية نحو الابتداع والإحداث في الدين، والمناقضة في الفكر. لذا قال رسوله الكريم: "مَن أحدث في أمرنا ما ليس من، فهو ردٌّ" [12]، ومعنى "في أمرنا": أي في ديننا. ومعنى "فهو رَدٌّ": أي مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: "كلُّ بدعة ضلالة، وكلُّ ضلالة في النار" [13].
ويرى الراسخون في العلم: أن البدع أشد خطرا من المعاصي؛ لأن المعاصي مكشوفة مفضوح أمرها للناس. أما البدع فهي تتستَّر بثوب الدين، وتروج بضاعتها عند الكثيرين على أنها قُرَب إلى الله تعالى، ولا يعرفون حقيقتها. ولذا قالوا: إن المعصية كثيرا ما نرى أصحابها يندمون عليها، ويتوبون ويستغفرون الله تعالى. أما البدعة فإن أصحابها لا يتوبون منها، ولا يستغفرون، لأنهم يتقربون إلى الله بها، فكيف يتوبون منها ويستغفرون؟!
ولهذا قالوا: إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. فإن المعصية تفسد الإنسان، ولكن البدعة تفسد الأديان.
• البدعة القولية (الاعتقادية والفكرية) والبدعة العملية:
والابتداع - كما شرحه العلماء - نوعان:
1. ابتداع بالفعل.
2. وابتداع بالقول.
وقد حذَّر العلماء من النوعين جميعا: بدعة الأفعال، وبدعة الأقوال.
وبدعة الأفعال تتعلق بالعمل والسلوك، وبدعة الأقوال تتعلق بالاعتقاد والأفكار.
ولذلك كانت البدعة الاعتقادية والفكرية: أشدُّ خطرا من البدعة العملية والسلوكية.
فإن الإنسان لا يستقيم سلوكه وعمله إلا إذا استقام اعتقاده وفكره وتصوره. فإذا اعوجَّ هذا الاعتقاد أو الفكر أو التصور: اعوجَّ العمل والسلوك لا محالة. إذ لا يستقيم الظلُّ والعود أعوج!
وهذا النوع من الابتداع والانحراف: هو سبب لكثير من الفتن والصراعات التي حدثت في تاريخنا الإسلامي، وأدَّت إلى حروب ودماء وخراب ودمار، وفرَّقت الأمة الواحدة إلى طوائف وفرق، يُفسِّق بعضها بعضا؛ بل يُكفِّر بعضها بعضا، وترتَّب على هذا: أن يقاتل بعضها بعضا، ويرفع أحدهم السيف في وجه أخيه المسلم؛ مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لهم في حَجَّة الوداع بالقول الصريح، والإنذار المبين: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" [14].
وقوله: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" [15].
إن بدعة الخوارج لم تنشأ عن فساد في السلوك أو تقصير في عبادة الله، فقد كانوا صُوَّاما قُوَّاما قُرَّاء للقرآن، حتى جاء في الحديث الصحيح: "يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم". ومع هذا وصفهم بأنهم "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة"، وأنهم "يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم" [16]، أي أنهم يقرؤونه بحناجرهم، ولا يحسنون فقهه بعقولهم. فآفتهم ليست في فساد القصد، بل في فساد الفَهم، آفتهم ليست في ضمائرهم، بل في عقولهم.
لهذا يقرر الإمام ابن تيمية في أحد المباحث في فتاواه : (أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة (أمراء) الظلم ، وقال في الذي يشرب الخمر : "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله" وقال في ذي الخويصرة : "يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين - وفي رواية من الإسلام - كما يمرق السهم من الرمية يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة" ) [17]
وهذا الاعوجاج في الفَهم أدَّى إلى الخروج على الأمة، واستباحة دمائها، حتى استباحوا دم ابن الإسلام البكر: علي بن أبي طالب!
وفي عصرنا نجد الابتداعات أو الانحرافات الفكرية هي أخطر ما يواجه الأمة، وهو ما يسعى أعداؤها بكل قوة، وبكل وضوح إلى تسويقه ونشره بين أبنائها، لتحريف مسيرتها، وتزييف وعيها، والتلبيس عليها، فلا تتبيَّن لها غاية، ولا يتَّضح لها طريق، وبهذا لا يمكنها أن تجتمع على شيء بيِّن. ولهذا كان أخطر أنواع الغزو الذي تواجهه الأمة المسلمة اليوم هو الغزو الفكري ، الذي لا يحاربنا بالسيف ، بل بالعلم ، ولا يهتم كثيرا بقتل الأفراد ، بل بقتل المجتمعات .
إن الأفكار (العلمانية) التي تنادي بفصل الدين عن الحياة والمجتمع. و(الليبرالية) التي تنادي بالحرية المطلقة للفسوق والانحلال والشذوذ والفواحش. و(الماركسية) التي تدعو إلى المادية الجدلية، ومقاومة الفكرة الدينية، ونسبية القِيَم الأخلاقية، وتحريم الملكية الفردية، ومصادرة الحرية الإنسانية: كلُّها ثمرة لهذا الابتداع أو الانحراف الفكري والاعتقادي. والثمرة لا بد أن تكون من جنس البذرة، {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً} [الأعراف:58].
لهذا كان لابد من كشف مساؤئها ، وبيان بطلان مبادئها ، ومقاومة انتشارها ، ووقاية الأمة من شررها وشرورها ، وكل هذا داخل في الجهاد.
مقالات مشابهه
آخر التحديثات
من قسم آخر
التقيمات
عاجل
راديو القمة

الأكثر قراءة
فيس بوك
a


















